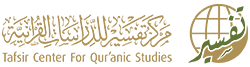القراءة الحداثية وإشكالات حقل التفسير
موقع رهان المعنى في القراءة الحداثية

يظهر على ساحة الدّرس التفسيري المعاصر الكثيرُ من النقاشات حول القضايا المركزية لهذا الفنّ، يرجع هذا -وفق بعض الباحثين- إلى وجود «إشكالات عميقة في هذا الفنّ»، ولعلّ من أبرز هذه الإشكالات هو «حالة الضبابية التي تعتري حيثيته ومفهومه»[1]، وموقع عملية استكشاف المعنى ضمن هذه الحيثية. وفي هذا السياق الخاصّ وشديد الأهمية يتم استحضار النقاش حول (القراءات الحداثية للقرآن)[2]، والتي فرضت نفسها كإحدى أهم المساحات على هذا الدرس، وهذا من جهة كونها تقدّم ذاتها بالأساس كتجديد في قراءة القرآن وبلورة فهوم واستكشاف معانٍ جديدة يعطّل فتحَ الباب أمامها مدونةُ التفسير التقليدية والطرائق والآليات الموروثة منها، والتي -وفقًا لهم- لا تزال تحكم النظرة المعرفية للقرآن فتجمّد معانيه وتكلّس فهومه، مما يجعل اشتغال هذه القراءات على صلة كبيرة بإشكال عملية استكشاف المعنى كأحد أهم الإشكالات ضمن حقل التفسير.
في هذه المقالة، وانطلاقًا من الأهمية الكبيرة للمعنى واستكشافه كحيثية مركزية في علم التفسير، سنحاول عرض الاشتغال الحداثي ضمن هذه القراءات حول قضية (المعنى) القرآني تحديدًا؛ طبيعته وطريقة تحصيله، لاستكشاف ما يمكن أن تقدّمه هذه القراءات حول هذا المعقد التفسيري شديد المركزية.
ولأجل هذا سيتركّز تناولنا بالأساس على عرض قضيتين رئيستين ضمن اشتغال القراءات الحداثية للقرآن لهما صلة مباشرة وحاسمة بقضية المعنى؛ القضية الأولى: هي قضية موقع (رهان المعنى) ضمن رهانات القراءات الحداثية سواء المعلنة أو الثاوية في الخطاب؛ لتبين مدى حسمِ هذا الرهان داخل بنائها التصوري والمنهجي. والقضية الثانية: هي قضية يثيرها الاشتغال الحداثي حول طبيعة النصّ القرآني لها صلة حاسمة بالمعنى، وهي قضية (أزلية النصّ)، وكون تعالِي النصّ وأزليته -كما يفترض بعض روّاد القراءة الحداثية- يتصل بتصور المعنى من حيث كونه واحدًا أم متعددًا، ثابتًا أم متحركًا، ومن ثم سنُسائِل هذا الاشتغال حول هاتين القضيتين في ضوء مركزية (المعنى) في الاشتغال التفسيري؛ لتبين مدى قدرة هذه القراءات -بما تطرحه حول المعنى واستكشافه- على إضاءة هذا المعقد المهم.
أولًا: نشأة القراءات الحداثية للقرآن، ورهان المعنى:
بالأساس لا يمكن فهم القراءات الحداثية للقرآن كخطاب معاصر حول القرآن والتفسير والمعنى والدين والحداثة، طالما ظلّ النظر إلى هذا النتاج كمجموعة معزولة من برامج القراءة المشغلة على القرآن، ففي حقيقة الأمر إن هذه البرامج بكلّ تصوّراتها النظرية وأُطرها وتقنياتها المنهجية التي تتوسل بها قراءة النصّ، تظلّ منغرسة في سياق خطابي أوسع يتعلّق بمسار التحديث وبالعلاقة بين الإسلام والحداثة ضمن هذا المسار وضمن التركيب المفترض من وجهة نظر هذا الخطاب كحلّ لمعادلة النهوض، حيث تتنزل هذه القراءات في سياق محاولة الخطاب الحداثي الانتقال في التعامل مع الإسلام والحداثة، من النمط (التجاوري)، أي: هذا النمط الذي يكتفي باستجلاب النتاج الحداثي المادي والفكري إلى جوار -وفوق وفي- موازاة التصوّرات الإسلامية للعالم، والذي بدأ وفق هذه القراءة مع الطهطاوي وعبده، نحو التعامل معهما بشكلٍ (تركيبي) عبر محاولة (القراءة العلمية للإسلام وللقرآن) بتطبيق المنهجيات الحديثة على الإسلام وعلى أعمق مساحاته، والذي بدأ مع طه حسين وزكي نجيب محمود، فهذا السياق -أو المنعطف بالأحرى- في تاريخ التناول الحداثي للإسلام وللحداثة، والذي يسميه مبروك: «التأسيس الثاني للنهضة»، هو وحده الذي يمكّننا من فهم العلاقة التي يفترضها هذا الخطاب بالقرآن وبالمدونة التقليدية وبالتفسير وبالمعنى وبالمنهجيات الحديثة.
ونشأة القراءات الحداثية في هذا السياق -سياق التأسيس الثاني، أو تصحيح مسار التأسيس الثاني-، وهو السياق التالي لواقعة (اهتزاز التقليد)، قد جعل القراءات الحداثية غير مشغولة بصورة مركزية بالاشتباك مع التقليد التفسيري الطويل سواء مدوّناته أو آلياته، حيث إن هذا التقليد كان قد خضع بشكلٍ كبيرٍ للنقد والتشكيك في صلاحيته فيما قبل نشأة هذه القراءات أصلًا، بل إنّ استبعاد التقليد التفسيري واصطناع المسافة معه كان قد تكرّس بفعل «قراءات ضدّ التقليد» -مثل تفسير المنار-[3]، التي أنتجت تفاسير متحرّرة من ثقل هذا التقليد وطرائقه وآلياته بصورة كبيرة؛ لذا فإن ما تركّز عليه اهتمام هذه القراءات في تناولها للقرآن هو أن يتم تقديم منهجيات جديدة لقراءة النصّ، وهذا لعددٍ من الأهداف المعرفية؛ أولها: ملء الفراغ المنهجي في تناول النصّ، وقد اعتبر فضلُ الرحمن مالك -أحد رواد هذه القراءة- هذا الفراغ المنهجي أحد أهم مشكلات التناول المعاصر للنصّ، وهو ما جعل عملية ملء هذا الفراغ ببلورة تأويلية موثوقة للقرآن هو الرهان الأساسي لتأويلة فضل الرحمن المقترحة[4]. وثاني هذه الأهداف: هو استكشاف فهوم جديدة تناسب التصوّرات الحديثة حول بعض القضايا الأنطولوجية (مثل العقلانية)، أو حول بعض القضايا الاجتماعية (مثل قضايا المرأة والتشريعات السياسية)، وهي الفهوم التي رغم طرح بعضها مسبقًا من قِبَل رواد النهضة دون ابتعادٍ كثيرٍ عن الآليات التقليدية أحيانًا؛ إلا أنها قد طُرحت -فيما يرى التناول الحداثي- بشكلٍ تلفيقي يطمح هو لتجاوزه بتأسيس هذه الفهوم بصورة معرفية أكثر تماسكًا.
إلا أن الجدير بالتنبيه هنا، هو أن هذه الأهداف المعرفية لم تكن الأهداف الوحيدة التي دفعت لاستحضار القراءات الحداثية لهذه المنهجيات الحديثة في قراءة النصوص، بل وبحكم السياق الخطابي الذي وصفنا فإنّ هذه القراءات كانت تهدف لهدف أعمق يتّصل بأهداف ورهانات هذا السياق الذي يمثل منعطفًا في مسار التحديث نحو «التحديث الجواني/ المعرفي/ التركيبي»، هو بالأساس دمج القرآن ضمن المنهجيات الحديثة وسقفها الإبستمولوجي والأنطولوجي، أو ما يسميه (أركون): «الزحزحة»، أي: نقل القرآن من «النظام الفكري والموقع الإبستمولوجي الخاصّ بالعقلية الدوغمائية إلى فضاءات التحليل والتأويل التي يفتتحها الآن العقل الاستطلاعي الجديد المنبثق حديثًا»[5]، وهو كذلك الهدف الذي يعتبر في ظننا أهم وأعمق ما في رهانات تأسيس (نصر) لمفهوم «التاريخية» أو «رهانها الإبستمولوجي» الأعمق، بما ينقلها من كونها أداة منهجية تضع التسييق التاريخي كمحدّد في إنتاج المعنى، لتصير تأطيرًا جديدًا لطبيعة النصّ يدمجه ضمن المنهجيات الحديثة كأعمق معاني الحداثة والعلّة المركزية لها.
فزحزحة أركون أو تاريخية نصر هي -وقبل الفهوم الجديدة وملء الفراغ المنهجي- محاولة لدمج القرآن ضمن الحداثة «جوانيًّا» كما يعبر عليّ مبروك، أي: عبر ربطه لا بنتاج الحداثة المادي (النتاج التكنولوجي، المؤسّسات العلمية والسياسية) أو حتى الفكري (النظريات والرؤى)، بل عن طريق ربطه بالحداثة «منهجيًّا»، مما يتجاوز من جهة التحديث السطحي والبراني المقتصر على نتاجات الحداثة ومعلولاتها عبر الوصول لعلّتها (المنهج)، ومن جهة أخرى يقطع الطريق على وجود أيّ مساحة من مساحات الإسلام -منطق الواقع الذي يشكّل أساس الوقائع بتعبير مبروك- مصونة ومنفية لحيز الوجدان بعيدًا عن أيّ «وعي علمي» بها، بتعبيرات نصر أبو زيد عن اشتغال زكي نجيب[6]، من هنا يظهر أنّ بُعد «استكشاف المعنى» سواء في عملية استحضار المناهج الجديدة أو في انتقاد المناهج القديمة =يتراجع عن أن يكون (ضمن رهانات الاشتغال الحداثي المرتبطة بسياقات نشأته) بُعدًا وحيدًا أو مركزيًّا أو متعلقًا بالمعرفة وحدها، بل إنه يبدو -مع استحضار هذا السياق- فرعًا لمجموعة أبعاد ورهانات أوسع، ربما أكثرها أهمية هو بُعد «تحديث الإسلام/ القرآن» عبر دمجه في المنهجيات الحديثة وإخضاعه لها.
وتأتي أحد أسباب هذه الأهمية الكبيرة المعطاة لـ(القرآن) وطرائق قراءته ضمن عملية التحديث الجوّاني هذه كمنعطف للخطاب الحداثي، من حيث كون طرائق تلقي القرآن ووفقًا لرواد القراءة الحداثية تُشكِّل ضمن العقل المعرفي العربي -المراد تحديثه جوانيًّا/ معرفيًّا- ما يمكن تسميته -استعارة من ألتوسير-: بـ(التحديد في المرتبة العليا)، أيْ إنها العامل الحاسم في تشكيل هذا العقل وإبستمولوجيته وطرائقه المعرفية؛ لذا فإن (تحديث العقل العربي) بما هو طريق التحديث المعرفي/ الجواني/ التركيبي لا يمكن أن يتم إلّا عبر تحديث طرق تناول القرآن، مما يعني كذلك أنّ (تحديث) هذه الطرائق لا يعود فقط لعدم كفاءة الطرائق القديمة والآليات التراثية في تناول القرآن من حيث دورها في عملية (استكشاف المعنى)، بل يعود بالأساس لعدم كفاءتها من حيث قدرتها على تشكيل (عقل حديث)، حيث لا تحمل هذه الأدوات هذه القدرة، ويعطل استمرارها في العقل أيّ انتقال حقيقي وجواني ومعرفي للحداثة، فالعقل التقليدي -أو حتى النهضوي الوارث له- هو فيما يرى الجابري عقل بياني أشعري لا يستطيع تحقيق الحداثة المطلوبة، تلك التي لا تنغرس جوانيًّا إلّا عبر تحديث هذا العقل وبالأساس من بوابة (القراءة العلمية للقرآن).
فالقراءة العلمية/ الحداثية/ التاريخية للقرآن هي ما يفضي -وفقًا للخطاب الحداثي- لتجاوز إشكالات (التفكير بالأصل المفارق للعقل)، ويعمل بتأكيده على مسائل السياق والتاريخ وقوانين تشكّل النصوص على تكريس فكرة القانون (النصّ، الاجتماعي، الطبيعي) كأحد مرتكزات الحداثة في مواجهة فكرة الإرادة اللاهوتية التي تنتمي للعصور السابقة عليها[7]، في عمق العقل المعرفي العربي الذي يمثّل مناط التحديث الجواني، هذا يعني أن (القراءة الحداثية للقرآن)، هي في عمقها مسألة تخصّ تحديث العقل أكثر ربما مما تخصّ استكشاف معنى جديد للنصّ!
أزلية القرآن وتفسير النصّ:
من القضايا الأساسية التي تواجهها (القراءة الحداثية للقرآن) هي قضية أزلية النصّ القرآني، ويتم النظر لهذه الأزلية كعائق تفسيري بالأساس، بمعنى أنها عائق عن فهم دلالات النصّ، وهذا عن طريق أنها تفترض كون المعنى غير محايث أو تاريخي، بل تجعله معنًى مفارقًا ومطلقًا ومتجاوزًا للعقل له بتعبير نصر أبو زيد: «إطلاقية المطلق وقداسة الإله»، بل يذهب أبو زيد إلى أبعد من هذا حين يعتبر أن النظر إلى القرآن كنصّ أزليّ هو أمر يفضي لغلق باب قراءة القرآن أمام العقل، ويفتح الباب للتفسيرات غير العقلانية والخرافية والإشارية من حيث لا يمكن حدوث التفسير بهذا وفقًا له إلّا عبر التوفّر على مواهب مفارقة[8]!
وهو ما استغربه بعضهم؛ مثل عليّ حرب حين قرّر تلك الحقيقة البسيطة، من كون جميع العلماء التقليديين الذين انطلقوا أصلًا من كون النصّ أزليًّا، جميعهم قد استخدم كلّ الأدوات العقلانية اللغوية والتاريخية وحتى الفلكية والطبيعية المتاحة له كي يفهم النصّ[9].
كذلك يربط نصر أبو زيد بكلّ وضوح بين الأزلية وواحدية المعنى وجموده من جهة فيتعبر أنّ «مفهوم قِدَم الكلام الإلهي يقتضي تثبيت المعنى الديني»، وبين التاريخية وتعدّدية المعنى من جهة مقابلة[10]، وهو الربط كذلك غير المفهوم حيث يؤسّس الكثيرون من القدامى والمعاصرين تعدّد المعاني على الأزلية بالأساس، مما جعل حيدر حبّ الله يتساءل: هل بالفعل احتاج البحث عن فهوم جديدة نَفْي قِدم النصّ[11]؟
هذا السؤال الذي يطرحه حبّ الله هو السؤال المركزي في ظنّنا، حيث يشفّ هو ومثل استغراب عليّ حرب عن جوهر الإشكال في التناول الحداثي لقضية الأزلية، وهو أنه وبكلّ بساطة لا علاقة من الأساس داخل القراءة الحداثية بين مواجهة أزلية القرآن والتفسير أو إنتاج فهوم جديدة؛ فنفي الأزلية هي قضية لا يمكن فهمها ضمن مستوى التفسير واستكشاف/ إنتاج المعنى بل ضمن مستويين آخرين تمامًا؛ مستوى عام هو موقع فكرة الأزلية من الفكر الحداثي في العموم -الذي وكما أسلفنا تشكّل القراءة الحداثية للقرآن منعطفًا في مساره-، ومستوى آخر أكثر تفصيلية هو تصادم الكثير من مساحات النصّ المركزية مع الكثير من مرتكزات الفكر الحداثي.
فبالنسبة للمستوى الأول فعلينا التنبّه أولًا لهذا الفارق بين الإنسان في المجتمع ما قبل الحديث أو المجتمع التقليدي، أي (الإنسان الحبري) بتعبيرات السيد حسين نصر، وبين إنسان المجتمعات الحديثة أي (الإنسان البروميثي)، هذا الفارق يقوم بالأساس على الصلة بما يسميه شايغان: «عالم الصور الأزلية»، حيث كان الإنسان في المجتمع قبل الحديث يعيش ضمن ما يسميه سيد حسين نصر: «الفلسفة الخالدة»، فيحيا تفكيرًا شهوديًّا لا يتوقف عند هذا العالم أو عند هذه اللحظة بل يتخطاها نحو (أركتيبات) أو (نماذج بدئية أزلية) تُمثِّل ذاكرة تجمع كافة الكينونات والموجودات، وكلّ استذكار (ذكر) لهذه (الميثات) و(الأركتيبات) هو استذكار ليوم: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} كما يسميه شايغان، وكان الإنسان (الحبري) باستجابته للرسالة يصل لهذا المَعِين الفيّاض الذي يُمثِّل مصدر وجود الإنسان ومآله ومعناه، في حين تقوم الحداثة على قطع صلة الإنسان بهذا العالم بالذات، فعلاقة الحداثة بعالم «الذاكرة الأزلية» هذا =هي وكما يخبرنا داريوش شايغان علاقة نسيان، حيث بدأ هذا الفكر بما يسميه «مكافحة الذاكرة»، فهجوم بيكون على «الأصنام الذهنية»، أو بلورة لوك لمقولة الصفحة البيضاء، أو ديكارت لمقولة العقل الفطري، من أجل تأسيس العقلانية الحديثة، هو هجوم على «الذاكرة الأزلية» أو «الأمانة»[12].
لذا فإن أيّ عملية تحديث هي في عمقها عملية مواجهة للصور النوعية الأزلية، وفي ظلّ اهتمام هذه العملية المحموم بالحادث والمباشر فإنها ترفض أيّ نزوع للاعتقاد في أيّ نماذج مسبقة، وفي ظلّ اهتمامها بالزمن فإنها ترفض أيّ نزوع للاعتقاد في أيّ حوادث (بدئية)، إلّا أن القرآن وبدعوى أزليته وأسبقيته على القرن السابع، وهي دعوى قرآنية بالأساس حيث يفترض القرآن -ومن مراحل مبكرة مِن تنزُّله- وجوده في عالم أسبق، في اللوح المحفوظ، فهو متنزّل من الأركتيب السماوي الأول والأصلي[13]، نقول: إنّ القرآن بهذه الدعوى يواجه الحداثة ذاتها في أحد مرتكزاتها الرئيسة، من هنا فإنّ نفي أزليته هي أحد محاور الاشتغال الحداثي على الإسلام والقرآن.
ويقوم نفي الأزلية على أساس فصْم الصلة بين القرآن الحالي والنموذج السماوي، بحيث يصبح النموذج الحالي هو مجرّد شكل تاريخي ومحدّد من هذا النموذج الأصلي، وبذا تنقطع صلة هذا الكتاب بالأزل، وهو ما يصرُّ عليه الشرفي حين يحدّد نفي القداسة والأزلية عن القرآن الذي بين أيدينا وقصر الإيمان بأزليته على صلته فقط بالكتاب السماوي، حيث يرى أنّ «قدسية النصّ لا تعارض تأويله»[14]، أي: قراءته علميًّا، حيث ما يؤول هو النصّ الداخل في سياق التاريخ، أو ما يعبر عنه أبو زيد بكون الاهتمام العلمي بالقرآن لا بد أن يقتصر على «لحظة تموضعه البشري»[15]، فهذا النفي يحقّق هدف دمج القرآن في المنظور الحداثي/ العلمي/ التاريخي، أكثر ما ينشغل بقضايا المعنى واستكشافه.
أمّا على مستوى تفصيلي فثمة بعض المساحات المركزية في القرآن التي تعارض كذلك بوضوح بعض مرتكزات الحداثة، أهمها مساحات القصص والشعائر وتجلي الآمرية الإلهية، فكما يقول الشرفي فإنّ هذه الأمور تنتمي للعالم القديم بميثولوجياته وعجائبه ولا تجد أيّ صدى لدى الإنسان المعاصر[16]؛ وهذا لأن القصص يمثّل مركز ما أسميناه -استعارة من شايغان- الصور الأزلية، فهذه القصص تروي فعال الله في التاريخ وتروي مجمل السردية الدينية من الأصل وإلى المآل، والتي تحدث في أزمنة بدئية (تتجاوز التقسيم الثلاثي للزمن إلى: ماضٍ، مستقبَلٍ، حاضرٍ)، وتبني العالم الديني للمؤمنين، وهذا لا يناسب الحداثة من حيث كونها نسيانًا للأزل وللمآل وتمحورًا حول الزمني والحادث، ومن حيث كونها ترفض اعتبار (الحقيقي) شيئًا غير الواقعي، وتقرأ القصص الديني من منظور الحقيقة التاريخية والعلمية فحسب، مما يعني ضرورة رفض هذا الجانب، فمواجهة أزلية القرآن لا تكتمل إلّا برفض ظلال هذه الأزلية داخله، والتي تتكثف في قصصه وشعائره بالأساس، عبر إحالة هذا الجانب لجزء من العالم القديم كما يقول الشرفي، أو عقلنته واعتباره قصصًا أدبيًّا أو تحويرًا دلاليًّا لتأكيد قيمة العقل بالمعنى الحداثي كما يرى نصر في قراءته لحضور الجنّ والشياطين والسحر في القرآن[17].
من هنا فلا يمكن النظر لقضية مواجهة أزلية القرآن باعتبارها قضية تتعلّق بالتفسير وبواحدية المعنى أو تعدّده وجموده أو حركيته، أو أنها تتعلّق بأدوات وطرائق التفسير، حيث تتعلق في حقيقة الأمر بما هو أعمق؛ أيْ: إمكان قراءة القرآن بشكلٍ حداثي من الأساس وإمكان دمجه داخل الرؤية الحداثية للعالم، وهذه السمة للقرآن -وبسبب ما يمثله من إشكال للحداثة- هي ربما أحد أهم أسباب انعطاف التعامل الحداثي مع الإسلام لمحاولة إنتاج قراءة حداثية للقرآن، حيث بدَا أنّ أيّ تعديل جزئي في فهم بعض مساحات الإسلام والقرآن لتناسب التصوّرات الحديثة عن التشريع والمجتمع والواقع لن يكون كافيًا في تكريس قيم الحداثة ما دام نمط حضور القرآن ذاته كنصّ أزلي معارضًا لها.
الاشتغال الحداثي ومشاغل حقل التفسير:
نستطيع إذن اعتبار أنّ القراءة الحداثية للقرآن تنطلق من محاولة الوصول لتحديث جواني عبر تحديث طبيعته ذاتها وعبر تجاوز أدوات قراءته نحو أدوات حديثة، وهذا من حيث إن طبيعة القرآن الأزلية تعارض بالأساس السمة المركزية للحداثة بما هي (نسيان الأمانة)، ومن حيث إنّ طرائق المعرفة بالقرآن تمثّل -وفق الدرس الحداثي- مركز العقل المعرفي العربي، والذي يُعَدّ تحديثه أساس التحديث الأعمق (الجواني/ المعرفي) لهذا العقل وضمان عدم برّانية وسطحية التحديث.
هذا يعني أن التعمّق في سياقات نشأة هذه القراءات وطريقة تناولها لعدد من الإشكالات المركزية ذات الصلة بالمعنى، وهو وحده ما يمكّننا من تجاوز الرهانات المعلنة نحو الرهانات الثاوية في منطق الخطاب والعلاقات بينها؛ يبرز كيف أن المعنى وإن كان أحد أهم رهانات القراءة الحداثية، إلّا أنه رهان ضمن رهانات أخرى أكثر حسمًا وانغراسًا في السياق الخطابي لها كأحد المنعطفات في مسار التحديث، رهانات لها دورها في بناء تعامل القراءة الحداثية مع القرآن وطبيعته ومع طريقة تلقِّيه والأدوات المتاحة لفهمه.
لذا فرغم انفتاح هذه الدراسات دعوةً وبشكل أقلّ تطبيقًا على المناهج المعاصرة في قراءة النصوص وما تفتحه من كثير من أفق الفهم، إلّا أنّ هذه القراءات ظلّت بشكلٍ كبيرٍ بعيدة عن تقديم ما يوفّر -حقيقةً- تطويرًا لعملية استكشاف المعنى، وهذا بسبب انغراس هذه القراءت في سياقات أوسع وأسبق وأكثر تجذّرًا، تجعل رهان المعنى -على أهميته- ليس الأهم بين هذه الرهانات.
[1] مقالة: مقاربة في ضبط معاقد التفسير؛ محاولة لضبط المرتكزات الكلية للعلم ومعالجة بعض إشكالاته، للباحث/ خليل محمود اليماني، منشورة على موقع تفسير: tafsir.net/article/5299.
[2] نطلق القراءات الحداثية على بعض النتاج المعاصر حول القرآن، وفقًا لعدد من المحدّدات التي تتعلّق بسياق نشأته وموقعه بين القراءات الأخرى. للتوسع في هذا انظر: سلسلة القراءات الحداثية للقرآن (1) - مدخل، المحددات الرئيسة للقراءات الحداثية للقرآن، منشور على موقع تفسير: tafsir.net/article/5079.
[3] قراءات ضد التقليد: هي قراءات نشأت في سياق اهتزاز التقليد، وقامت باصطناع مسافة سلبية مع التقليد، حيث اهتمت بتجديد نتاج التفسير لا طرائقه، وكان تعاملها مع هذه الطرائق سلبيًّا، حيث حاولت التخفّف منها في بناء متونها. انظر: القراءات الحداثية للقرآن (1) - مدخل، المحددات الرئيسة للقراءات الحداثية للقرآن، موقع تفسير: tafsir.net/article/5079.
[4] انظر: القراءة الحداثية للقرآن (7)، فضل الرحمن مالك؛ القرآن والحداثة والتأويلية الناجزة، موقع تفسير: tafsir.net/article/5140.
[5] وهي إستراتيجية مستمرة في كتابات أركون؛ حيث يجري تعديلًا على كلّ المفاهيم المتعلقة بالقرآن، القرآن والآية فيجعلها «الظاهرة الإسلامية»، و«الظاهرة القرآنية»، و«الوحدة النصية المتمايزة»، من أجل أن يتخلص من الحمولة اللاهوتية المشحونة بها هذه المفاهيم لدمجها في سياق المنهجيات الحديثة. انظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص27، 75، هامش: هاشم صالح، في ص119.
[6] النصّ، السلطة الحقيقة، نصر حامد أبو زيد. المركز الثقافي العربي، ط1، 1995، ص42.
[7] للتوسّع في فكرة الانتقال من الإرادة للقانون كرهان أساس للقراءة الحداثية للقرآن خصوصًا في اشتغال نصر أبو زيد، انظر: القراءات الحداثية للقرآن (2)، نصر أبو زيد وطبيعة القول القرآني، أولًا: الأبعاد السياسية والاجتماعية لخطاب نصر أبو زيد، موقع تفسير: tafsir.net/article/5095.
[8] نقد الخطاب الديني. دار سينا، القاهرة، ط2، 1994، ص206.
[9] نقد النصّ، علي حرب. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط4، 2005، ص206.
[10] النص، السلطة الحقيقة. المركز الثقافي العربي، ط1، 1995، ص33.
[11] الوحي والظاهرة القرآنية، إعداد وتقديم: حيدر حب الله. مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ص27.
[12] انظر: الأصنام الذهنية والذاكرة الأزلية، دار الهادي، ط1، 2007، ص25، 98.
[13] انظر: وجهان للقرآن: القرآن والمصحف، أنجيليكا نويفرت. ترجمة: حسام صبري، منشورة ضمن الترجمات المنوعة على قسم الاستشراق بموقع تفسير: tafsir.net/translation/42.
[14] الإسلام والحداثة والثورة، عبد المجيد الشرفي. دار الجنوب، تونس، 2011، والهيئة العامة للكتاب، مصر، 2012، ص179، 180.
[15] نصر حامد أبو زيد؛ النصّ، السلطة الحقيقة. المركز الثقافي العربي، ط1، 1995، ص97.
[16] الإسلام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي. دار الطبيعة، بيروت، ط2، 2008، ص45.
[17] انظر: القراءة الحداثية للقرآن في خطاب نصر أبو زيد، ثانيًا: تأسيس مقولة التاريخية، موقع تفسير: tafsir.net/article/5099.
مواد تهمك
-
 نصر أبو زيد وطبيعة القول القرآني، أولًا: الأبعاد السياسية والاجتماعية لخطاب نصر أبو زيد
نصر أبو زيد وطبيعة القول القرآني، أولًا: الأبعاد السياسية والاجتماعية لخطاب نصر أبو زيد -
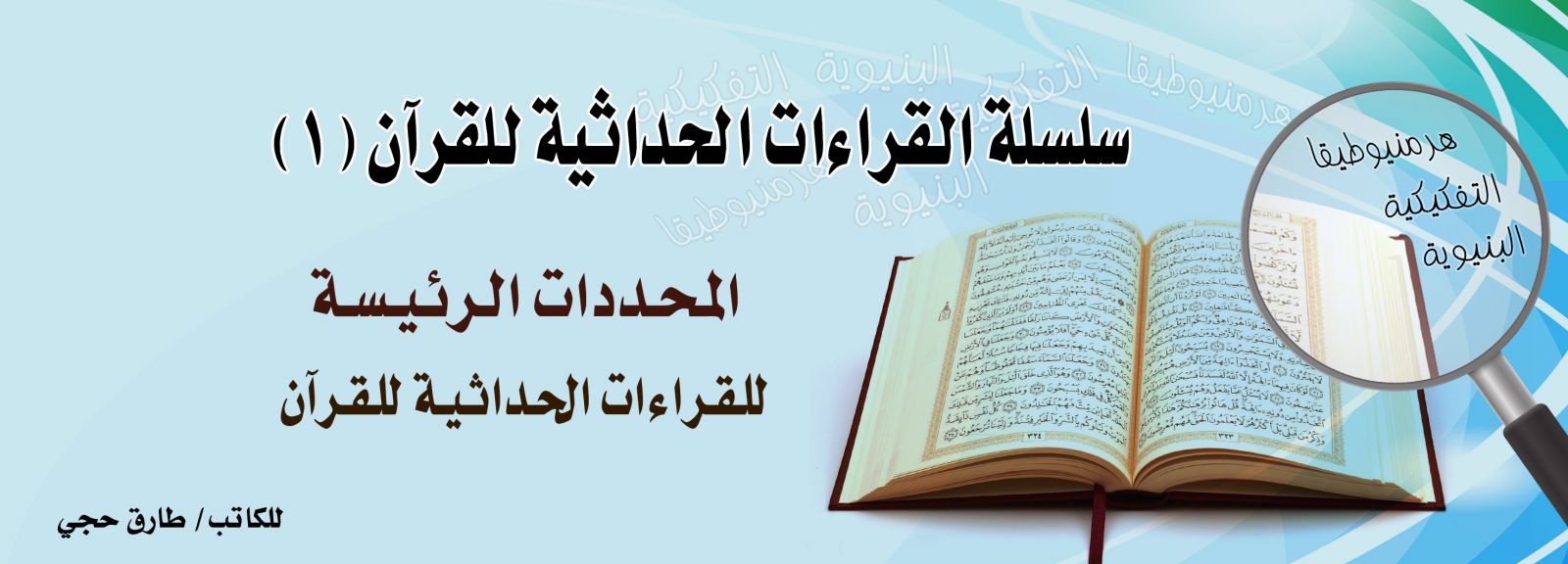 مدخل، المحددات الرئيسة للقراءات الحداثية للقرآن
مدخل، المحددات الرئيسة للقراءات الحداثية للقرآن -
.jpg) عبد المجيد الشرفي، القرآن وتحديث الإسلام
عبد المجيد الشرفي، القرآن وتحديث الإسلام -
 القراءات الحداثية للقرآن؛ تحليل لسياقات النشأة ونقد لأسس الاشتغال
القراءات الحداثية للقرآن؛ تحليل لسياقات النشأة ونقد لأسس الاشتغال -
.jpg) الإسرائيليات في الدرس الحداثي للقرآن
الإسرائيليات في الدرس الحداثي للقرآن -
 نصر أبو زيد وطبيعة القول القرآني، ثانيًا: تأسيس مقولة التاريخية
نصر أبو زيد وطبيعة القول القرآني، ثانيًا: تأسيس مقولة التاريخية